رحلتي مع القصيدة النثرية
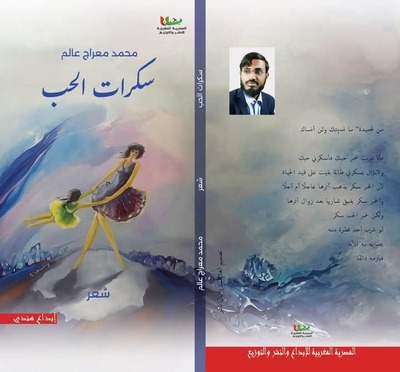
القصيدة النثرية نوع شعري حديث النشأة، ظهرت متمرّدة على القصيدة التقليدية التي تتقيّد بالأوزان الخليليّة، حيث تخلو من الوزن والقافية ولكنها تتلافى ما نقصها بتجردها من الوزن والقافية بالإيقاع والتناغم الداخليّين والإيحاء وقوّة التخيّل، فلذا مازالت القصيدة النثرية ولاتزال تعيش بين الرفض والتأييد، فالبعض يرفض كونها نوعا شعريّا لأنها تخلو من الوزن والقافية مما يبعدها من إطار الشعر. ولكن اختلط الحابل بالنابل بسبب اختلاط الشعر بالنظم رغم أن بينهما بون شاسع يختفي على المتلقي لو امتنع من التعمق. وتحدث جرجي زيدان في تاريخ آداب اللغة العربية عن التمييز بين الشعر والنظم، فكأنّه يؤيّد القصائد المتحرّرة بما فيها القصيدة النثرية، لأنّه يكتب متحدثا عن مفهوم الشعر وتعريفه" فهو لغة النفس أو هو صور الخيال لحقائق غير ظاهرة،.....هذا هو تعريف الشعر في حقيقته، ولكن علماء العروض من العرب يريدون بالشعر الكلام المقفى الموزون فيحصرون حدوده بالألفاظ، وهو تعريف للنظم لا للشعر، وبينهما فرق كبير، إذ قد يكون الرجل شاعرا ولا يحسن النظم، وقد يكون ناظما وليس في نظمه شعر، وإن كان الوزن والقافية يزيدان الشعر طلاوة ووقعًا في النفس، فالنظم هو القالب الذي يسبك فيه الشعر ويجوز سبكه في النثر". ومن ثمّة يتّضح أن القصيدة النثرية أو الشعر المنثور لا يخالف روح الشعر، لكنّه متحرّر من النظم، فلذا حسب رأي جرجي زيدان يمكن أن يطلق على القصيدة النثرية اسم الشعر المنثور، بينما لا يجوز إطلاق اسم الشعر المنظوم عليها، إلا أن جرجي زيدان يعترف بأن علماء العروض يريدون بالشعر الكلام الموزون المقفّى، ولكنّه يفنّد آرائهم قائلًا: " هو تعريف للنظم لا للشعر". فيبدو هنا أن جرجي زيدان سبق محمد أنسي الحاج وأدونيس في تأييد القصيدة النثرية، ولكن لم تظهر القصيدة النثرية فعلا إلا في الستينات من القرن العشرين.
أودعتُ كتابة القصيدة منذ صغري، فعندما كنت أتعلم في كُتّاب قريتي الموسوم باسم " كُتّاب مسيح الأمّة" أسمع وأنشد قصائد في المديح النبوي باللغة الأوردية، وكنت أحاول أن أكتب القصيدة على منوال الشعراء الذين أنشدُ قصائدهم في النوادي الأسبوعية الطلابية في كُتّاب القرية، والجدير بالذكر أن الأستاذ الذي علّمني الحروف الأبجدية هو مولانا حديث الله نصر البهاغلفوري، وهو كان يدرّبني على أن أنشد قصيدة المديح النبوي على منوال شاعر المديح النبوي غلام ربّاني قاصر البهاغلفوري، وأعطاني أستاذي مولانا حديث الله نصر عدة مجموعات لقصائد المديح النبوي التي قرضها غلام ربّاني قاصر البهاغلفوري باللغة الأردية، فكنت أشغل نفسي كثيرا بقراءة تلك المجموعات الشعرية، حتى بدأت أنظّم بعض الأخيلة البسيطة في قالب الشعر، وكنت أكتبها على الورق ثم أخرقه دون أن يراه أحد، لأنني كنت مصابا بمشاعر النقص، وأتجنّب ظهورها للآخرين خوفًا من العتاب وتثبيط الهمّة، حتى التحقت بمعهد إسلامي موسوم باسم"جامعة الخلفاء الراشدين بفورنية" عام 2007م، وكنت كعادتي كلّما تثور معان في خاطري أكتبها على الورق وأخرقه، وأصبحت أهتمّ أكثر بإخفاء ما كنت أنظّمه من القصائد، لأن خوف العتاب ازداد في تلك المرحلة، لأنني وجدت هناك بيئة تنافسيّة حيث كان بعض زملائي يقرضون القصائد ويعرضونها على الأساتذة ويتلقّون استحسانا من قبلهم. وبقي أمر الإخفاء على حاله حتى التحقت بمعهد إسلامي موسوم باسم"الجامعة الإسلامية بمظفرفور أعظم جراه" عام 2011م، وبدأت أعرض هنا قصائدي أمام بعض زملاء الصفّ، وكانوا يسمعون مني و يشجعونني عليه، وقصائد هذه المرحلة موجودة بين دفّتي الدفتر، ولكنّي أعتقد أنّها ليست أكثر من محاولة بسيطة في مجال كتابة القصيدة باللغة الأوردية خالية من النضج الفكري والوزن الشعري، وواصلت كتابة القصيدة الأردية حتى جاءت مرحلة انقطعت فيها إلى كتابة القصيدة بالعربية، وانتهت رحلتي مع القصيدة باللغة الأردية، وكاد أن ينمحي الاسم الشعري الذي كنت أستخدمه لنشر قصائدي الأردية، وهو " حبيب بدر"، ولا أدري هل مات ذلك الشاب الذي كان يحاول كتابة القصيدة باللغة الأردية ودفن في التراب؟ فلا يمكن أن يعود من القبر حيًّا، أو أغمي عليه إغماءة لم يفق منها حتى الآن؟ وانتهاء رحلة كتابة القصيدة بالأردية بداية لرحلة جديدة، وهي رحلة كتابة القصيدة بالعربية.
وأما رحلتي مع كتابة القصيدة باللغة العربية فلم أكن أتخيّل قط أنني أكتب القصيدة النثريّة، لأنني في بداية الأمر بدأت كتابة القصيدة العمودية، وكتبت عدة قصائد عمودية موزونة، وذلك عندما كنت في السنة الأولى من الماجستير بجامعة جوهر لال نهرو بنو دلهي، والأليق بتلك القصائد أن تسمّى بأنها كانت مجرد محاولة بسيطة بالكاد تتوافق مع العروض الخليليّة، لأنني لم أعرضها قط على خبير في علم العروض لكي يهذّبها ويزنها بميزان الشعر، رغم أنّه كانت لديّ معرفة قليلة بالبحور ولكنّي كنت أتهرّب من تقييد المشاعر بالبحور ووزنها بالأوزان الشعرية، وذلك خوفًا من ضياع المشاعر التي تثور في القلب وتلف الأخيلة التي تنشأ في الدماغ، فكلّما تنشأ عواطف في قلبي ويدفعني دافع إلى قول الشعر فكنت أصوغ المشاعر التي تختلج في قلبي في قالب القصيدة العموديّة،منها بيت:
لوكانت العبادة جائزة لغيره
لصرت أنت العبادة وصلاتي
والقصائد العمودية التي كتبتها ليست كثيرة، وهي تتراوح بين عشر قصائد وخمس عشرة قصيدة، وضاعت معظمها لأنني لم أهتمّ بحفظها، وكنت أرى أن الوزن أكبر عائق في نقل المشاعر من القلب إلى الورق، والأفكار تختنق في بعض الأحيان بسبب الالتزام بالقافية والبحر، وكان الأمر كذلك حتى تعرّفت على القصائد النثرية في السنة الثانية من الماجستير، وبدأت أسمع قصائد نزار قباني ومحمود درويش عبر قنوات اليوتيوب، ومن ثمّة وجدت أن القصيدة النثرية أوفق لي، لأنّها تعطيني حرّيّة كاملة في إبداء المشاعر في قالب الشعر بدون الالتزام بالوزن والقافية، فقرأت بعض نصوص القصائد النثرية لنزار قباني ومحمود درويش، وحفظت بعضها عن ظهر القلب. وأردت هنا أن أكتب القصائد النثريّة، ولكنّي لم يكن لي أن أتعرّف على التقنيات الفنيّة اللازمة لقصيدة النثر، فلجأت إلى الناقدة الفلسطينيّة الدكتورة ميّادة أنور الصعيدي، وعرضت أمامها بعض القصائد وطلبت منها أن تصحّحها حسب التقنيات الفنية اللازمة فشجّعتني كثيرًا وزوّدتني ببعض كتاباتها التي درست فيها دراسة تحليلية لبعض القصائد، فهي بمثابة معلّمة لي. وواصلت السير على طريق القصيدة النثريّة، وكنت أعرضها أمام الباحثين وأطلب منهم إبداء الرأي فيها، ولتطوير التقنية الفنية أنشأت ملتقى باسم ملتقى البحث والإبداع متكونا من عدة أعضاء لهم إلمام بكتابة النصوص، فكنّا نجتمع فيها افترضيا على مدار نصف شهر، حيث يعرض فيه كل واحد منا نصّه الذي كتبه حديثا وينتقده الآخرون ويظهرون آرائهم فيه، وكنت أقدّم فيه قصائدي النثرية، وهذا الملتقى كان من إحدى البواعث على كتابة القصيدة النثرية، ولكن مع الأسف تفكّك الملتقى بتفكّك الأعضاء. وهناك دافع آخر لكتابة القصيدة النثرية، وهو مشرفي ومعلمي الدكتور محمد أجمل لأنّه يسمع منّي كل قصيدة أكتبها سواء كان حضوريا في مكتبه أو افتراضيا على الاتصال، ثم يبدي رأيه في القصيدة من الناحية الفنية، وكنت أصحّحها حسب رأيه، فأنا أشكره شكرا جزيلا على هذا العطاء الجميل، حيث أنّه وفّر لي العطاء الجميل، وكذلك كتب كلمات أحلّي بها جيد الكتاب، كما أتقدّم بهدية الامتنان الكبير إلى الروائية والشاعرة السعودية ريما آل كلزلي، لأنّها كتبت تقديما جيّدا وتحدثّت فيه عن ميزات القصائد الفنية وانتقدتها نقدا بنّاءا. كما لا يفوتني توجيه الشكر إلى الروائية السودانية آلاء محمد الأمين وأختي الكريمة الكاتبة تبيان محمد الأمين، حيث بذلت كل واحدة منهما جهودا جبارة في التدقيق اللغوي للقصائد.















