الشّاعر والصّحفي أيمن اللبدي في حوار مع ديوان العرب
أيمن اللبدي: "ديوان العرب هو أصل النشر الإلكتروني باللغة العربية على الشبكة"
موجز السّيرة الذّاتيّة للضّيف:
أديب وكاتب وشاعر وصحافي فلسطيني وُلِد في مدينة طولكرم الفلسطينية.
عمل في مجالات التعليم والصحافة والتسويق
رئيس تحرير صحيفة «الحقائق الثقافية»
نائب رئيس تحرير صحيفة «الحقائق الدولية»
رئيس تحرير مجلة «حيفا لنا»
له عدة مؤلفات أدبية وشعرية ونقدية مطبوعة
عضو الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، ومسؤول تجمّع الأدباء والكتاب الفلسطينيين.

- نعودُ إلى البدايات، كيفَ اكتشفَتِ القصيدةُ طريقَها إلى عالمكِ؟
ومن أوّل مشجّع لكَ؟
القصيدة بالمعنى التوصيفي الناضج عندي هي ثمرة عشرينية ولدت في خضم الحراك الجامعي بالشكل التام الممكن به الولوج بثقة لها، وأعتبر ما سبق وسلف كان إرهاصات شعرية رغم كثرتها وتنوّع موضوعاتها، والدفقة الشعرية الأولى كانت في الواقع خلال مراحل متقدمة ربما في أثناء الدراسة الوسيطة، بيد أنها ما لبثت تنضج وتتبلّور حتى وصلت إلى ما يمكن اعتباره اكتشاف وفرض.
الأهم هو البحث في المولد خلف هذه التجربة من الاكتشاف إلى التكريس، وثمة ثلاثة شواحن في هذا الجانب: (الديني والوطني والذاتي) هذه كانت المثلث المقدس، وربما الأول كان أساس خروجها بالشكل المكرّس بعضهم يستخدم عبارة الكلاسيكي، لا بأس أعني العمود، والآخران كانا خلف تطور الشكل من الحر وأحيانا تجربة النسيقة مرات محدودة.
لا أظن أني أذكر مشجعين بالمعنى التوصيفي هذا، ولكن هناك من لفتته هذه الإشارات، وفي البدايات الأولى كان هناك أخ وصديق تكفّل بشرح مادة بسيطة حول العروض وتزويدي بملخص عنه هو الأخ (بلال الجيوسي) ابن بلدي طولكرم في سبعينات القرن الماضي، وأذكر لاحقا كيف حرمني الاحتلال من الحصول على جائزة مدرسية حول الكتاب واستخدم مدرسي اللغة العربية ليعترضوا على أن القصيدة تخالف بحور الخليل.
والمدهش أني صدمت عندما فهمت أن هؤلاء لم يكن لهم علم بالكامل المذيّل ولا المرفّل أو أنهم صدموا أني كنت أعرف هذا وبالتالي سقطت حجة الاحتلال الذي أراد إلغاء فوز قصيدة تتحدث عن القرآن وعن ضرورة الوفاء للقدس ولفلسطين، هذا أهم ما يرد في خاطري عن تلكم الأيام.
تلك المرحلة كانت القصيدة وولادتها أشبه بمرحلة تلقي إشارات ومطاردتها فهي مرهقة ومتعبة ومؤلمة أحيانا وتشهد المراحل التي وصفتها في مسألة الشعر والشعراء في الشاعرية والشعرية ولا تشذ عنها كثيرا.
- ما هوَ عملكَ الأدبيّ الأوّل الذي خرجَ للقرّاء، كيف تمّ استقباله، هل انتابكَ قلقٌ ما؟
العمل العلني الأول هو ما وصفت لك آنفاً، إذ أعلنت مديرية التربية والتعليم بعمل مسابقة للمدارس الثانوية في المنطقة حول الكتاب شعراً وقصصا ومقالا، ونظمت قصيدة حول القرآن وتقدّمت بها إلى هذا الإعلان من خلال الثانوية الفاضلية، وكانت زوبعة إذ صادف قرار منعها واستبعادها أشبه ما يكون بمسرحية لم تنطل عليّ طبعا.
بعد ذلك دعا إخوة إلى إلقاء قصيدة بمناسبة المولد النبوي وكان أن أقيم احتفال بذلك في مركز الشباب الاجتماعي بمخيم طولكرم، ونالت القصيدة استحسان الحضور وقدّمت لي كما أذكر يومها جائزة معنوية عبارة عن ماكنة حلاقة، لم يكن قد ظهر بعد احتياج لها في تلك المرحلة.
ما بعد البدايات كانت في الجامعة، جامعتي العزيزة بيرزيت وكان أول قصيدة ألقيها عام 1981 فيها بعنوان (لن نركع)، وافتتاحية اكتشاف شاعر وطني كانت حقا في ذلك اليوم من أيام تشرين الأول في بيرزيت.
وفي أثناء سِني النضال الوطني والطلابي خرجت باكورة صغيرة لمجموعة شعرية لا تتعدى بضع قصائد نشرتها أغلبها الصحف الفلسطينية في القدس مثل الفجر والشعب آنذاك وكذلك مجلة البيادر الثقافية والكاتب الحيفاوية وغيرها وحملت عنوان (من وصايا النزف) في بداية الثمانينيات منشورة في موقعي الشخصي.
مسألة القلق لم تكن متوفرة بالمطلق لأن هذه النصوص جرى أصلا نشرها وسماعها وإعادتها وكثيراً استخدامها بل إن بعضها وجد طريقه ليصبح شعارات مرحلة اتسمت بالعمل الثوري والوطني بشكل عام.
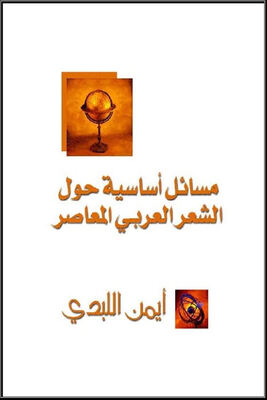
– في كتابك(مسائل أساسيّة حول الشّعر العربيّ المعاصر) ترى أنّه انتشر الزّجل الشّعبيّ في سورية ولبنان، والشّعر النّبطيّ في الجزيرة العربيّة، وتتساءل:
هل هذه النّصوص هي شعر أم لا؟
ماذا كان الرّأي الأخير الّذي وصلتَ إليهِ؟
الرأي الأخير باختصار كالتالي: الشعرية العامة ليست حكراً على القصيدة، بل هي في كل لمحة من لمحات الحياة قولا أو عملا، لأن الشعرية والشاعرية تقيس بمعادلة بسيطة فيزيائية أو كيميائية أو مهما خطر لك في طبيعتها، هذه تقول باختصار إن أنتج الكلام تأثيراً ما فهو شاعري لا شك بذلك لأانه أمكن الشعور به، ما تلا ذلك إن أنتج أثراً في المتلقي بعد ذاك هذه مسألة أخرى تتبع عوامل كثيرة منها الجودة والصدق وأمانة الرسالة ومستويات أخرى لا داعي للافاضة حولها.
أما الشعرية الخاصة والموصوفة فهي تتقيّد بالضبط بالوصف التقعيدي للمسألة، وبذا هذا جميعه إن لم يكن قابلا للدخول في هذا القالب التوصيفي تماماً فهو ليس قصيدة بهذا المستوى والمعنى ولا شعر، ولكنه لطيف في ناحية أخرى منفصلة تماما.
أظن أني قلت ذات الشيء عن النسيقة التي يسميها كثيرون بقصيدة النثر والومضة وغير ذلك.
- يرى البعض أنّ كتابة الشاعر قصيدة غزل - في زمن الحرب- أمرٌ مستنكَر.
ما رأيك؟
لا أظن أن هناك علاقة تصل لحد الاستنكار بل على العكس تماما الحرب إن كانت هي الحرب التي نعيشها نحن منذ قرن كامل أي الحرب من أجل الوجود واستعادة الوطن واستعادة دورنا الحضاري المسلوب منذ قرن كامل ما وصفت يصبح ضرورة وليس مدعاة استنكار.
إن أصل المقاومة محبة وعلاقة حب قاعدية متأصلة ومثلها ما ينتج عنها من فداء وتضحية، والثائر الحقيقي هو الثائر العاشق المحب، وأوافق الكومندانتي تشي جيفارا في هذا المنحى وما وصل إليه أن شعر الحب هو طلقة إضافية في جعبة الثائر.
في مرحلة ما تصبح التشابكية بين حب الأرض وحب المرأة ناضجة تماما ولا يمكن فصلهما، بل إن تطورهما معا هو مرحلة أصلانية لتعميق مولدّات الفعل والعطاء والتسامي فإن انتكست قادت إلى انفجار واضمحلال.
بحسب تجربتي كانت المرأة معبرا إضافيا للاصرار الثوري والوطني أيضا ومسرحا جديدا لتمثيل كمالهما معاً وعندما تكون المرأة أيضا بذاتها مناضلة وأديبة تصبح العلاقة رفيعة المستوى المثالي في القصة.
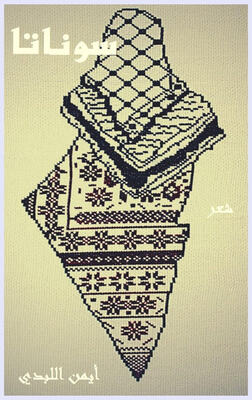
- هل خبتِ القصيدة الفلسطينيّة المقاوِمة عمّا كانت عليه عن زمن (محمود درويش)؟
القصيدة المقاومة الفلسطينية تحديدا لا يمكن إلصاقها بزمن شاعر أو شاعرة أو جيل كامل هذا رأي، لكن الملاحظ الأدق في القصة أنها تتبع حركة موجية لا خطوط مستقيمة في القصة.
القصيدة التي تغنى بها عبدالرحيم محمود رغم محدودية ما وصل إلينا منه والمشهورة للجميع والتي يقول فيها (سأحمل روحي على راحتي) إبان أحداث معركة الشجرة في فلسطين في منتصف الأربعينات وخواتيمها، مثل القصيدة التي تغنى بها إبراهيم طوقان وأصبحت لاحقا نشيدا وطنيا لعدة دول قطرية عربية (قصيدة موطني) ومثل قصيدة عبدالكريم الكرمي( أبو سلمى) ابن بلدي والتي يقول فيها (وطن يباع ويشترى وتصيح فليحيا الوطن، لو كنت تبغي عزه لدفعت من دمك الثمن).
هذه قصائد كلها تتبع المنهاج الشعري القديم وكلها أنتجت أجيالا تندفع إلى الميادين والشوارع عندما كانت تسمعها وقدمت على وقعها الثورة الفلسطينية الأولى عام 36 وقدمت الدفاع عن فلسطين وما سبق أحداث النكبة، هذا زمن أقول بكل وضوح أن القصيدة المقاومة فيه كانت مخزن رصاص كامل وهذا زمن الموجة الأعلى.
الفترة التي تلت النكبة لم تكن تحمل سمة موجات كاملة في طابعها، بل نتيجة تشظي المجتمع الفلسطيني نفسه وتمسرحه على طيف واسع من الفكر وأحيانا الأيديولوجيا أصبح الوضع مختلفا، بينما حملت قصائد معن بسيسو وسواه النفس الشيوعي، حملت قصائد هارون هاشم رشيد النفس الميّال للحنين الى أيام الموجة الأعلى وكذا فعلت قصائد فدوى طوقان، وبينما خرج راشد حسين ليؤسس موجة مقاومة جديدة رعى فيها مجموعة شعراء منهم درويش وسميح القاسم وربما توفيق زياد بصخب عال النبرة دعا غسان كنفاني لتحويط هذه الثمرة الجديدة بتسمية مجلجلة باسم شعراء المقاومة بالأرض المحتلة، بقي كثيرون يراقبون هذه الموجة.
في مرحلة ما كانت قصائد هؤلاء الرائعين في الأرض المحتلة وعندما كان لا يزال درويش بها، كانت نبراسا تحريضيا جميلا على الإبداع وكانت الاستجابة لها عالية وأيضا كانت أنوارها ساطعة، بعيد خروج درويش واندماجه في مرحلة توصيفية وحكائية مرافقة لأحداث استهداف اللجوء والشتات الفلسطيني حدث هناك خلخلة على مستوى التوقع بين الرغبة في إخراج المدهش والحفاظ على الحبل السري لقصيدة المقاومة وهو تون التحريض أو بشكل أدق زخم الشحن.
أقول هنا أنا لا أخفي رأيي أبدا، أقبل قصيدة بدون فلسفة وبلا فنون عالية المستوى إن أنتجت لي فدائيا أو هرّبت لي صندوق ذخيرة.
القصيدة التي قالها مثلا صخر حبش من نمط (لازم تزبط) عندي أهم من قصائد متأنقة تبحث في كأس أو دورق عن معنى الخلاص.
باختصار هناك زمن كان فيه درويش نفسه جزءا من مسار هكذا قصيدة ولكن أغرته قصة الفلسفة ولا يمكن القول أن القصيدة المقاومة الفلسطينية قد تراجعت عن فعلها هي بعد تراجعه هو عن كونه أحد أهم موجهي دفتها السابقة، ودعينا لانخطيء هنا فأنا عندما أسمع أغنية علي فودة (إني اخترتك يا وطني) أحس أنها لا تقل عظمة عن (مرفوع الهامة أمشي) أبدا .
يعني صعب جدا قفل زمن القصيدة الفلسطينية المقاومة على أي نقطة في المسار والمنخنى لخلق نقطة اشتقاق دائمة عليه.
- اسمكَ مُدرَج بين شعراء العربيّة من شعراء فلسطين المهمّين، وفي أكثر من موقع تصنيفي للشعراء العرب، ومن أشهر قصائدك القصائد المكتوبة لمدينة القدس والتي أطلق عليها "مقدسيّات"، ماذا ستختار لنا منها؟
لا أعرف من يحدد المهمين من غير المهمين لكن أشكرك على الإشارة إلى مقدسيات، وذلك لأني أحس أن القدس لا زالت شعرا بعيدة عن الوفاء لها بجزء مما لها علينا، أنا أدعو شعراء جيلي كلهم إلى الانتباه لهذا الجانب، القدس تستحق منكم أكثر.
لا أريد أن أردد كلام درويش مرة أنه يحسد الشعراء اليهود على أنهم قالوا في القدس آلاف ما قلناه ونحن أصحابها وأبناؤها وورثة مجدها، ولكن للأسف لا أملك أن أرد كلامه.
هؤلاء الذين يقسمون هم إن أرادوا وصف غلظ أيمانهم بقولهم شلّت يميني إن نسيتك يا قدس وهم مجرّد مدّعون، يختصرون علينا لائحة تحدي حمراء من الحجم الكبير ....السؤال ماذا نفعل نحن قبل ذلك وبعده؟
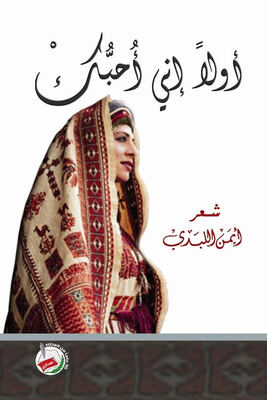
انظري للمسألة من فوق بلوريا وبانورامياً، لا في المسألة الدينية قلنا ما يكفي، ولا في القومية فعلنا ذلك، ولا حتى في الإنسانية صنعنا هذا...أبدا نحن حتى في التجارة والعمران تخلفنا عن القدس.
أختصر لك هذه الأبيات من المقدسيات من آخر قصيدة حول الإسراء والمعراج:
إنَ الوفاءَ إذا لم يَشْتعلْ غضباً
فالفَوْتُ فيهِ تبدَّى وإنْ جَلّاهُ إبطاءُ
ونصفُ زعمكَ إنَّ اللهَ حارسُهُ
بلى ويحرسُ اللهُ جنداً فيهِ قد فاءوا
جنودُ يحيا على الأسوارِ تحرسها
بنو فلسطينَ آباءٌ وأبناءُ
- ما رأيك بترجمة الشّعر؟
ترجموه للدراسة، للبحث، للاطلاع أما ترجمة بمعنى إعادة تخليق اللحظة الكمية شعريا فلا.
هذا لن يعود شعراً حتى لو نظمه مجددا على أصول صنعته أحدهم في لغة المترجم لها، هذا محسوم لدي ولا أظن أني قد أعدّل في هذا المجال شيئا مذكورا.
- نلتَ عدّة جوائز وتكريمات، منها جائزة درع القصيدة العموديّة من مهرجان (سوق عكاظ) ضمن أسبوع فلسطين.
هل ترى أنّ التّكريمات والجوائز الحافز الأقوى للإبداع؟
لحظة، كل هذه الجوائز والتكريمات كانت بريئة عذرية تماما، لسببين الأول أنها كانت في مرحلة مبكرة لا تتجاوز المرحلة الأولى من سياقاتي الأدبية وبذا فإن دورها كان يقول إلى حد ما تخوم ما قد وصفت بسؤالك آنفاً وعندما اختارت جامعتي قصيدة تتألف من 365 بيتا شعريا لتعطيها جائزة درع سوق عكاظ كنت فخورا بهذا فعلا ، والثاني أنها كانت في سياق أكاديمي وطني خالٍ من فجوات المناولة والمبادلة، لا أعرف كيف أبسّط ولكن كانت حيث لا أتخيّل أن تكون خارج تلك الإحاطة.
لكن ما حدث تاليا وفي مراحل أخرى من التجربة الأدبية خاصة بعد مغادرة فلسطين التي أجبرت على مغادرتها آنذاك في منتصف الثمانينات أني اكتشفت في قصة الجوائز و(التكريمات) شيئا آخر يختلف تماما ولذا وقد تستغربين ما سأقوله لكِ هنا، أصلا مقابلاتي كل كم سنة ، ولقد رفضت عشرات المقابلات المكتوبة أو المسموعة وبالذات المرئية والفضائية منها خاصة، يعلم هذا عدد من الأصدقاء المقربين، فإنا لست مقلاً فقط في هذه المسائل بل أكاد أكون متزمتا لأبعد حد فيها، لماذا لأن هذا يفضي إلى هذا، وكل هذا بل وجميع هذا غدا منذ فترة ليست بالقصيرة مجرّد سوق.
لا تستغربي الأمر هي سوق بما فيها نوبل نفسها فضلا عن كثير من تلكم العربية المصدر، منذ أن سلّع الأمريكي وهو الأنجلوسلكسون المتواضع أصلا بأي إنجاز أدبي عالمي، منذ أن فعل للثقافة والأدب والفن ما فعله للرياضة وتعليب السجائر، والقصة كلها سوق بقوانين السوق المعلومة، وأحيانا بالمطوّر منها.
الأدب العالمي الحقيقي البلوري هو اللاتيني والروسي والعربي (المكتوب بالعربية) غير ذلك عبارة عن فصول في أدب ما ولا أوافق أنه أدب شامل وخاصة الأنجلوساكسون منه أو النورماندي أو حتى الجرماني.
في الصورة غضبت يوما من درويش وقلت له في مقالة:
أنت يا صديقي شاعر جائزة....رحم الله شاعرنا درويش فقد كان فارسا رغم ذلك وقيمة فنية فلسطينية، فماذ يمكن أن أقول عن أدونيس أو غيره في هذا الجانب مثلا؟َ
جوابا لسؤالك ببساطة: لا أراها كذلك...
- هل أدى الإعلام العربيّ، والأدباء العرب دورهم تجاه الشّعب الفلسطينيّ؟
هل لدينا حرية حرف في المشرق؟
أظن أنك اطلعت على مقالة «لا نبحث عن زوان» الأخيرة ومعك حق بالسؤال، أفترض أنك اطلعت عليها، عموما هذه لحظت مرحلة الطوفان تحديدا وما بعده وهي الفترة الأهم في حياة الشعب الفلسطيني وكنت أظن أنها ستكون الفرصة الأبرز ليقول العرب كلمتهم فيها فهي تتيح لكل من لم يكن له دور في أي زمن آخر أن يقول، فماذا كانت النتيجة وماذا كانت الصورة؟ حسناً أكتفي بالمقال كموقف وإجابة.
وكل ما سبق من أسئلة ذكية أمكن الإجابة فيه ببساطة ومباشرة لكن لهذا السؤال سيرهقني ويرهقك ويرهق القارئ لأن فيه سبحا طويلا عموما اسمحي لي أن آتيك بأجوبة مختصرة:
الإعلام العربي أنواع ومواسم وفصول، والأدباء العرب كذلك هم عزيزتي، فالإعلام الذي يسمى شتاء ولديه القدرة أمطر في دار الآخرين وإن حمّل الشعب الفلسطيني دوما أنه يحبه، أذكر صرخة درويش(ارحمونا من هذا الحب) والإعلام الربيعي أزهر في حقول خيال لا علاقة له بالواقع ولا يمكن أن يكون جدياً في مهزلة التخيلات هذه ، أما الإعلام الصيفي والخريفي فهو لا يحضر هكذا ببساطة هو ملك لأشياء أخرى وآخر اهتمامها الشعب الفلسطيني اللهم إلا إن جاء له طلب عاجل للعب دور تنغيصي أو تشكيكي أو تشويش من أي نوع كان.
ما ينطبق على الإعلام ينطبق على الإعلاميين طبعا.
عزيزتي: الإعلام اليوم أم السوق وأبوه وجده كذلك، فما رأيك بأجوبة حول السوق؟
فقط ربع بالمائة يخص ما يسمى إعلام المقاومات يحاول أن يقلع بطائرة غير نفاثة وندعو له الله أن يفعل ما تبقى مسرح آخر.
أما الأدباء فهي مسألة أخرى، صحيح أنهم متنوعون كذلك، ولكن باختصار حالهم ليس بأحسن من حال أدباء فلسطين (كلهم في الهمّ شرق) ، وشرق أغلبهم (خوف ولا رجاء) فالأفضل أن نختصر في مسألة الأدباء ختام حساب لجواب كهذا كل يسأل نفسه، أما أنا لا أحب أن أضع جوابا سوى كان الله بعون الجميع ونشكر من قدّم ولن نعتب على من أحجم أو توانى أو حتى اختفى هذا شأنه.
إذا كنت حراً ستخرج موقفاً لكن إن كنت غير ذلك فوضعك موقف أصلاً.
إن جوهر التعب في القصة كلها أن هناك إعلاما وأدبا وأدباء غير محكومين بسقوط سقوف الشرق وهم في الغرب وفي الجنوب ومع ذلك كان دورهم عند المحصلة لا يختلف كثيرا عمّن هم هنا، هذا يحيلنا إلى الأساس في الصورة، كله غدا سلعة وكله غدا سوقا للأسف إلا ما رحم ربك.
– كلمة لموقع ديوان العرب
وما هي مقترحاتك لتطويره؟
ديوان العرب ليس موقعاً ولا مشروعاً شخصياً فقط هذا أولاً
وثانياً ديوان العرب هو أصل النشر الإلكتروني باللغة العربية على الشبكة وأعلم ذلك لأني أعلم أن جهد وإصرار وعمل (عادل سالم) كان منذ تسعينات القرن الماضي في التجربة بكاملها يوم لم يكن هناك في الإيميلات إلا برنامج أمريكا أون لاين وبعدها بسنوات جاء الهوت ميل والياهو ثم ما ترينه اليوم.
عادل بدأ منذ أيام مجموعات الياهو العربية لكتب، وينشر باللغة العربية على الشبكة ويتبنى موقعا لخدمة الثقافة العربية والأدباء العرب والمثقفين العرب، أعلم ذلك تماما وأضيف لك لولا هذا الموقع لربما تأخر خروج أسماء كثيرة أو حتى تغييب أسماء كثيرة منها، بل إن مشروعنا الجمعي تجمع الكتاب والأدباء الفلسطينيين كان لعادل دور محوري في نفاذه وولادته.
إصرار أخي عادل جميل وغريب في آن، يعني يكفي ربع الصدمات التي من الممكن أن يواجهها مشروع هكذا في عالم العرب للتخلي عنه للأبد، لكن عادل ملهم في هذا المجال ودعيني أقول أن هذه الصلابة بحد ذاتها إنجاز وبصمة.
موقع ديوان العرب بصمة عندي أهم من مواقع مؤسسات كثيرة على الشبكة العنكبوتية لديها ميزانيات بالأرقام العابرة للأصفار الستة، وأهم من برامج سخيفة حاولت تقليد نشاط عربي قديم كان يقام في المدارس الثانوية بأسلوب استعراضي وثقيل الجيب ومثقل بالاعلانات، انظري سوق في النهاية.
دعيني هنا أحاول أن أقول للناس:
لا تخلطوا بين الثقافة والدراية، الدراية نعم أن تعرف شيئا عن معظم المواضيع وأن تعرف كيف تتعامل مع علائقها، وأن يكون لك ذوق فني أو فكري أو اجتماعي وأن تدري كيف تتخلص من المواقف والصعوبات وتجتاز الاختبارات وما تريدون، هذه دراية تدخل فيها الدربة وتدخل فيها القراءة والمذاكرة والاطلاع.
الثقافة شيء مختلف، الثقافة تعني أن تفهم مرتكزات الفكر وتشعباته، الثقافة الانتماء للفكر والعقل والروح والوصول إلى منطقة الظل بكامل الاقتدار، الثقافة أن ترفع ما أمكنك من حياة البشر إلى أعلى ما استطعت وأن تنير لهم طريقا ما للخلاص بأنواعه.
أظن لديوان العرب بصمة من هذا النوع.
يعني إن كنت تقصدين التطوير الشكلاني، لا أريد أن أقول يحتاج لهذا، بل على العكس أقول لعادل لا تتورط بالصورة أبدا، هذه باتت وسيلة إلغاء ومراهقة، دع عنك البودكاست والتيكتوك واليوتيوب وأخواتها، إن بقي على الشكل الأصلاني في رأيي هو قمة التطور، أما إن أردت الجوهر فلا أظن أن هناك أكثر من اقتراح إضافة وتركيز على التراث الشعبي الفلسطيني بكل مفرداته من أول الحادي وصوت دلال أبو آمنة وناي البرغوثي إلى آخر اللبس والفخاريات الفلسطنية.
محبتي لكم جميعا وشكري أيضا وتمنياتي بكل التوفيق والرشاد...















